دكتور كلمة لاتينية الأصل تعني معلم . أما اليوم، فقد صارت لقباً لكل الذين وصلوا في علومهم إلى أعلى ما تستوعبه مقاعد الدراسة الجامعية، أياً كانت هذه العلوم. ولكن هذا اللقب في الواقع أكثر من ذلك. فهو يجمع في قيمته البحث العلمي إلى الفرص الوظيفية إلى المكانة الاجتماعية، ويطمس الاختلاف النوعي في الأبحاث والمجهودات المبذولة للحصول على اللقب نفسه ما بين تخصص وآخر، وما بين جامعة وأخرى.
فكيف بدأت شهادة الدكتوراه، وما هي حقيقة ثقلها في الميزان العلمي والاجتماعي في حياتنا اليوم؟
فيما يأتي أربعة إسهامات تبحث في هذه القضية، أولها يعرِّف بماهية هذه الشهادة والعوامل المؤثرة في قيمتها وجدواها، والثاني يتناول تاريخ الدكتوراه وتطور برامجها في الجامعات الغربية. أما الإسهام الثالث فيبحث في حال هذه الشهادة وإشكاليتها في المملكة. والرابع يعرض خلاصة واحد من الكتب البارزة التي تتناول قضية الدراسة الجامعية وتدعو إلى تغيير ثقافتها.
الدكتوراه جواز مرور لا نهاية مطاف
لقاء مع الدكتور أهيف سِنُّو
للتعرف إلى ماهية شهادة الدكتوراه وقيمتها وما تتأثر به هذه القيمة سلباً أو إيجاباً، التقت القافلة بالبروفسور أهيف سِنُّو، نائب رئيس جامعة القدِّيس يوسف للدراسات العربية والإسلامية في بيروت، ومدير معهد الآداب الشرقية، ومدير المعهد العالي لإعداد الدكتوراه في علوم الإنسان والمجتمع، وكان لنا معه اللقاء الآتي نصه:
• كيف تُعرِّف شهادة الدكتوراه لمن لا يعرفها، وبماذا تختلف عن الشهادات التي دُونها؟
• لتقديم جواب واضح، يُستحسن الانطلاق من الدرجة العلمية التي تسبق الدكتوراه مباشرةً، أي الماجستير أو ما يُعادلها كدبلوم الدراسات العليا. فإن شهادة الماجستير تُمهّد السبيل أمام شهادة الدكتوراه، وهي تأتي بعد الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس مباشرة. وتتيح شهادة الماجستير للطالب أن يُعمّق تخصصه الذي اختاره عادةً في المرحلة الجامعية الأولى، أي البكالوريوس، من خلال دراسة مجموعة من المواد المقررة التي تختلف باختلاف الاختصاص والجامعات، وبحث جامعي يسمى رسالة (بالفرنسية: Mémoire، وبالإنجليزية: Thesis)، يُشرف عليها أستاذ متخصص ويزيد عدد صفحاتها عادةً على المئة، وذلك حسب الاختصاص والجامعات أيضاً. والرسالة بحث علمي يَرمي بشكل عام إلى تقويم منهج الطالب في بحثه، أكثر مما يرمي إلى حمله على الاكتشاف والاختراع، وهو يُؤهّله للإعداد للدكتوراه.
أما شهادة الدكتوراه فتتيح بدورها للطالب أن يزيد تعمقه في تخصصه من خلال مجموعة من المواد الجديدة، وإعداد بحث جامعي آخَر يُسمّى عادة أطروحة (بالفرنسية: Thèse، وبالإنجليزية: Dissertation). وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدكتوراه قد تطوَّر عالمياً: ففي فرنسا مثلاً، كان إعداد دكتوراه الدولة يقتضي إعداد أطروحتين: أطروحة ثانوية، وأطروحة أساسية. ثم ميَّزوا بين دكتوراه الاختصاص أو الحلقة الثالثة، ودكتوراه الدولة، ثم ألغي نظام شهادتَي الدكتوراه هذا، وحل محله نظام الدكتوراه الواحدة، لأن مفهوم الدكتوراه قد تغيَّر: فقد كانت دكتوراه الدولة مثلاً لتكلل حياةً حافلةً بالنشاط العلمي ويُنجزها المتخصصون في سن متقدمة، بينما أصبحت الدكتوراه الواحدة في الأنظمة الجديدة جواز مرور إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ومهما كان الأمر، فإن الأطروحة بحث علمي يُشرف عليه أستاذ متخصص أو أستاذان. وهو أوسع من الرسالة، فيتطلب نَفَساً طويلاً (ثلاث أو أربع سنوات عادة)، وجهداً منهجياً معيناً، وهو أرفع مستوى من الرسالة، ويرمي إلى الإتيان بجديد ذي شأن في الاختصاص المنشود، من الناحية النظرية، وناحية النتائج العملية. ومن شأن الأطروحة أن تدل على طول باع صاحبها في البحث والتحليل والنظر، وعلى قدرة الباحث على معالجة أبحاث أخرى من غير أستاذ مشرف.
• ما هو تقييمك لحامل هذه الشهادة اليوم وكيف تؤثّر الشهادة في حاملها ؟
• نشهد اليوم تفاوتاً بالغاً بين حَمَلَة الدكتوراه: فالقيمة العلمية لصاحب الأطروحة هي من قيمة أطروحته. ومن هنا يمكن القول إن الأطروحة تؤثر إيحاباً أو سلباً في صاحبها. فحتى سنين قليلة خَلَت، كان الرجل العادي في بلداننا العربية ينظر إلى الدكتور نظرة تقديرٍ وتبجيل؛ ولكن يجب أن نعترف أن تغيراً طرأ على هذه النظرة، وأن الرجل العادي نفسه بات لا ينظر إلى لقب دكتور النظرة نفسها.
• مَن في نظرك الجدير بحمل هذا اللقب، هل هو كل متخرج؟
• لا، فإن الصدق والصراحة يقتضيان الاعتراف بأن اللقب في نهاية الأمر ليس كل شيء، وأن حامل اللقب قد لا يكون أهلاً له، شئنا ذلك أم أبيناه. فجدارة حامل اللقب بلقبه أمر يحتاج إلى نَظَر. لذلك، ينبغي أن نأخذ عدة أمور في الحسبان، كالطرح الذي تقدِّمه الأطروحة، والجهد المنهجي المبذول فيها، ومتانة مستنداتها، وعمق تحليلها ومعالجتها، وتماسك بنائها، وسلامة تعبيرها؛ نضيف إلى ذلك دقة النتائج التي توصلت إليها. يعني هذا الكلام أن الأطروحة هي أساس التقويم أو التقييم، بالنظر إلى مواصفاتها التي هي غير مواصفات الكتاب. فباختصار، ينبغي للأطروحة أن تكون وثيقة علمية صارمة منهجاً ومضموناً وشكلاً، حتى يستحق صاحبها اللقب الذي يحمله.
• إلى أي مدى يؤثِّر دور الجامعة والهيئة المانحة للشهادة في مستوى الدكتوراه ؟
• لا شكّ في أن طريقة إعداد الدكتوراه تؤثّر في مستوى هذه الشهادة، وأن للجامعة ولجنة المناقشة مثلاً دورًا في ذلك. فلا بد من لفت النظر هنا إلى أمرين على الأقل: المؤسسة المانحة أولاً، ولجنة المناقشة والتقرير الذي تضعه ثانياً.
إذ يختلف الواقع باختلاف البلدان والجامعات. فلا يخفى مثلاً أن التنشئة العلمية في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أفضل مما لدينا اليوم في عالمنا العربي في كثير من الحقول، نظراً إلى إمكانات البحث المتوافرة هناك، من موازنات، ومختبرات، ومناهج، وتقنيات... ولكن لا يخفى أيضاً أن من أطروحاتنا ما يوازي ما يعد في الغرب، بل ما يفوقه أيضاً، على الأقل في بعض المجالات. لذلك لا بد من التنبه إلى تكاثر الجامعات الناشئة في العالم العربي، وانصرافها بعد سنوات قليلة من إنشائها في أحسن الحالات إلى منح شهادات الدكتوراه. فإن عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا تصنيفاً رسمياً للجامعات فيها. أما في بلداننا فيتحدثون عن اعتراف الدولة بالجامعات أو اعتمادها مثلاً، من غير أن نعرف المعايير التي اعتمدت في هذا الاعتراف أو ذلك الاعتماد: أهي سياسية، أم استنسابية، أم غير ذلك...؟ وإن قالوا هي علمية، فليتنا نعرف ما هي.
لقد حاولت بعض الأجهزة عندنا وضع بعض المعايير، ولكنها غالباً ما كانت معايير شكلية، كعدد الأساتذة من حملة الدكتوراه، وعدد المختبرات، وعدد المؤتمرات التي تُعقد كل سنة... من غير تطرّق إلى إنتاج حَمَلة الدكتوراه، وبرامج البحث في المختبرات، وغير ذلك. لذا، يتعين على الجهة المانحة أن تكون صاحبة تقاليد عريقة في البحث العلمي، وأن تتوافر فيها الموارد البشرية المؤهَّلة للإشراف على الأطروحات، في الحد الأدنى.
كذلك، تُمثّل لجنة المناقشة دوراً أســــاسياً في منـــــح الشــــهادة وتقديرها. فهي بالنتيجة التي تُجيز الأطروحة أو لا تُجيزها، وتمنحها علامة معيَّنة أو تقديراً معيناً. لذلك ينبغي أن تتألف من أصحاب الكفاءة العالية، والضمير الحي أخلاقياً ومِهنياً. ويتعين عليها وضع تقرير مفصَّل يتناول شؤون الأطروحة وشجونها. ومثلما تفاوتت الجامعات فيما بينها، نجد هنا أيضاً بين لجان المناقشة تفاوتاً في تقدير الأبحاث، حتى في المؤسسة الواحدة.
• هل من حاجة إلى تجديد أساليب منح الدكتوراه أو وضع أسس جديدة لتقييم الطلبة، تُساير التطور وتُؤهّل الطالب فعلاً لخدمة مجتمعه ؟
• ترمي الأبحاث الجامعية -ومنها الرسائل والأطروحات- إلى التنشئة العلمية. وأول ما ينبغي لنا البدء به هو تربية أبنائنا على مقومات المعرفة العلمية والروح العلمية والتحصيل الأكاديمي. فمن دون تنشئة على الموضوعية، والمنهج، والحس النقدي، والأمانة، والنزاهة، والعمل الجماعي ضمن فريقٍ معيَّن، عبثاً نحاول إصلاح الأمور. وحبذا لو يُدرك طالب الدكتوراه أنه مُقبل على مشروعٍ علمي كبير يحتاج إلى عدة كاملة، ومثابرة، وفضول علمي. فبئس الأطروحة التي لا يرمي مُعدُّها إلاَّ إلى وظيفة، أو منصبٍ، أو تحسين مستوى المعيشة.
وقبل أن نُفكّر في وضع أسس جديدة، حبذا لو نطبِّق الأصول المتعارف عليها في مرحلة إعداد الدكتوراه، وذلك على مُستوى التدريس، والبحث، والإشراف على الرسائل، ومناقشتها. وبما أن الدكتوراه أصبحت جواز مرورٍ -حسبما رأينا- لا نهاية مطاف، فيجب أن نتأمل ما يجري بعد الحصول عليها: وعلى ضوء ذلك نسعى إلى سدّ بعض الثغرات في مناهجنا. فالذين تولَّوا مسؤوليات جامعية يعرفون أن من حَمَلة الدكتوراه من لا يستطيع أن يُدرِّس أكثر من ساعتين أسبوعيتين منحصرتين في مجال أطروحته. من هنا الحاجة إلى الانفتاح على أبواب التخصص الأخرى للإفادة منها وتوسيع آفاق البحث والعمل.
إن الباحث في الأدب مثلاً، يُفيد اليوم بالتأكيد مما تُقدمه علوم كثيرة كالألسنية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا...؛ ولا شك في أن إفادة الآداب من هذه العلوم الإنسانية سيُؤدي إلى تَرقّي مستوى الأطروحات الجامعية في الاختصاص هذا. كذلك، يجب أن نحثّ حَمَلة الدكتوراه على متابعة إنتاجهم العلمي، وأن نوفِّر لهم الإمكانات اللازمة للقيام بأبحاثهم حتى بعد تخرجهم.
تاج الدراسة يحتاج إلى دراسة
حنان أحمد عبد الحميد
بدأ ظهور شهادات الدكتوراه في الجامعات الأوروبية منذ القرون الوسطى. وكانت عبارة عن رخصة تسمح لحاملها بممارسة مهنة التعليم، ولم يكن هناك فرق بينها وبين درجة الماجستير، فكلاهما كان يُستخدم للدلالة على المعنى نفسه، ولم تكن هذه الرخصة تشبه في شيء درجات الدكتوراه الحاضرة التي يعدّ البحث العلمي الفريد شرطاً لنيلها.
كانت ألمانيا الدولة الأولى التي أعطت شهادة الدكتوراه صورتها المعروفة اليوم بإنشائها جامعة برلين عام 1810م على يد هامبولدت. وكان الحصول على الدرجة يتطلَّب حضور حلقات دراسية، وإعداد رسالة بحث علمية واختباراً شفهياً شاملاً، ويركِّز على الأصالة والإبداع بصفتهما عنصرين أساسيين لنيلها. كذلك كان أعضاء الهيئة التدريسية لهذه الجامعة مطالبين بحمل شهادة الدكتوراه وإجراء الأبحاث العلمية ونشر المواد الثقافية، وأدى هذا إلى ذيوع صيت هذه الجامعة عام 1815م؛ فجذبت ذوي العقول المتقدة والنفوس الطموحة من بريطانيا وأمريكا. وعاد الطلاب الأمريكيون إلى أوطانهم، وبدأوا بدفع عجلة الدراسات العليا إلى الأمام وأدخلوا مفهوم الأبحاث وشهادة الدكتوراه إلى الجامعات الأمريكية عام 1860م. وكانت جامعة يال (Yale) أول جامعة تتبنى هذه الشهادة، تبعتها جامعات هارفرد وميشيغان وبنسلفانيا. بعد ذلك وصل مفهوم شهادات الدكتوراه الجديد إلى بريطانيا عام 1917م بدءاً من جامعة أكسفورد، ثم انتشرت في أرجائها وفي الدول التي تتحدث الإنجليزية مثل كندا وأستراليا.
أنواع شهادات الدكتوراه
تعددت أنواع درجات الدكتوراه واشتهرت. وأشهرها ثلاثة: أولاً الدكتوراه في الفلسفة (Doctor of Philosophy)، وهي درجة دكتوراه بحث تولي الجانب النظري اهتماماً كبيراً، ثانياً الدكتوراه المهنية (Professional Doctorate) وهي درجة دكتوراه بحث أيضاً تركِّز على جوانب تطبيقية وعملية أكثر من النظرية، وانتشرت بعد شهادات الدكتوراه في الفلسفة لحاجة السوق لها، وأخيراً درجة الدكتوراه الفخرية (Honorary Doctorate) التي تعطيها الجامعة لفرد تقديراً لإسهامه وإنجازه المتميز في مجال معيَّن، من دون أن يكون هذا الفرد قد خضع للمتطلبات الدراسية اللازمة لذلك..
الدكتوراه في الولايات المتحدة
تجذب برامج الدكتوراه في الولايات المتحدة عدداً كبيراً من الطلاب من مختلف أرجاء العالم، وعلى الرغم من قوة هذه البرامج إلا أن قضية تقييمها وتطويرها موضوع أساس على جدول كثير من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، الأكاديمية وغير الأكاديمية. وليست أعمال التقييم والتطوير هذه نابعة من خلل أو ضعف في هذه البرامج، بل من طبيعة العصر الاقتصادية والتقنية والمعرفية والسياسية المتسارعة التغيُّر.
انتشر الفكر الداعي إلى مشاركة جميع الجهات المؤثرة والمتأثرة في إعداد برامج الدكتوراه بما يتناسب مع حاجة كل جهة، فهذه البرامج ليست حكراً على الجامعات فقط؛ بل ان للطلاب والباحثين والممولين والموظِفين ونحوهم الحق في التخطيط لها. وأسهمت في إذكاء روح هذا الفكر انتقادات الدراسات الوطنية لبرامج الدكتوراه بأنها تركِّز على الدراسة أكثر من التدريب، وبأنها لا تشجِّع ترابط العلوم، ولا تخرج الكفاءات اللازمة لشغل المناصب القيادية، ووصفتها بأنها طويلة وبطيئة في تلبية حاجة المجتمع المتغيرة بسرعة. وهذا ما نتج عنه تكريس جميع جهود الفئات المعنية لبلورة تصور جديد لبرامج الدكتوراه يتماشى مع حاجة المجتمع.
وتسهم مؤسسات الدولة الاتحادية أيضاً في الإعداد لبرامج الدكتوراه، وتتعالى الآن نداءات المسؤولية -التي ابتدأت في مؤسسات التعليم الأساس والجامعي- الموجهة إلى الجامعات العامة. فجميع من فيها مسؤول عن الكفاءة النوعية لبرامج الدكتوراه وعن استثمار أموال الدولة فيما يعود عليها بالنفع المماثل، وتغلق الهيئات الحكومية البرامج التي أثبتت عدم جدواها، وتخفض المخصصات المالية لبرامج الدكتوراه بما يتناسب مع المردود الملموس منها، وتصدر التوصيات بافتتاح أبواب تخصص تخدم المجتمع، وتعديل وتطوير أخرى، ومراعاة الموازنة بين العمق واتساع معرفة حامل الدكتوراه ومهارته.
ربط فروع المعـرفة وربط حقولها
ومن أبرز التوجهات الآن في برامج الدكتوراه الأمريكية المبادرات والبرامج الجامعة بين فروع مختلفة من المعرفة. وتلاقي هذه المبادرات دعماً من جميع الجهات الحكومية والمهنية والأكاديمية. ومن الأمثلة على هذه البرامج، المحاولات الجادة لطالبة دكتوراه في مجال الهندسة العصبية -في جامعة إموري ومعهد جورجيا للتقنية- لصناعة خلايا عصبية محوسبة تُزرع عند الأشخاص المصابين بشلل دماغي فتمكِّنهم من المشي! ومثال آخر بسيط على الجمع بين المعارف المختلفة: المصباح الضوء صوتي اليدوي الذي يمكِّن الطبيب والممرض من الرؤية عبر جلد المريض عند حقن إبرة أو قطع جلد بمشرط. وتجمع أوجه التطبيق العملية بين العلوم الحيوية والطبية والهندسية والتقنية وغيرها وبين المتخصصين في هذه المجالات.
وتجري الآن دراسات على أساليب تقنين ممارسات الربط بين العلوم المختلفة في برامج الدكتوراه. ومن هذه الممارسات تأليف باحِثَيْن رسالة دكتوراه بدلاً من واحد، وتعيين أكثر من مشرف في أبواب تخصص متنوعة لطالب الدكتوراه ونحو ذلك.
سوق العمل والدكتوراه
يجد حاملو الدكتوراه بشكل عام مجالات عمل مناسبة. ونسبة البطالة بينهم منخفضة وتبلغ %1.1، وهي أقل من غيرهم ممن يحملون درجات علمية أدنى، ورواتبهم أعلى منهم إذ يبلغ المعدل السنوي 66000 دولار (2001م).
وتنقسم أنواع الوظائف لحاملي الدكتوراه إلى نوعين: وظائف أكاديمية، وغير أكاديمية. فالوظائف الأكاديمية مناصب تدريس أو إدارة أو كليهما في الجامعات والكليات، وهي ساحة تنافس تجذب شريحة كبيرة منهم، خصوصاً أصحاب أبواب التخصص الإنسانية والاجتماعية. أما الوظائف غير الأكاديمية، فهي أيضاً تستقطب شريحة واسعة منهم لا سيما ذوي التخصص العلمي والهندسي.
وتجري الولايات المتحدة دراسات لبحث أسباب بطالة %1.1 من حاملي الدكتوراه. فهذه النسبة تخص ذوي التخصص الدقيق جداً في برامج الدكتوراه، إذ لا يجد هؤلاء مكاناً وظيفياً مناسباً خارج نطاق الأكاديميات ومراكز البحث. ويعزى بعض الفائض إلى تخريج ما يزيد على حاجة السوق للاستفادة من طلاب الدكتوراه أثناء مكوثهم في الجامعات في مشاريع بحث ومهام تدريس.
الدكتوراه في المملكة المتحدة
تركيز أكبر على المهارات
تحاول الجامعات البريطانية اللحاق بمثيلاتها الأمريكية في ساحة المنافسة العالمية، وتهتم بالتطوير النوعي للبرامج بتركيزها على التدريب واكتساب المهارات، والعناية برسالة البحث والمشرف والطالب، وإدخال معايير وطنية.
فقد أشار تقرير روبرتز (2002م) إلى أن تركيز برامج الدكتوراه على تحضير رسالة البحث أدى إلى الفشل في إدراك حاجة الطلاب إلى اكتساب نطاق واسع من المهارات، كذلك تشير فرص التوظيف المحدودة لخريجي الدكتوراه في المؤسسات الأكاديمية إلى الحاجة إلى تدريبهم على شغل مناصب متنوعة خارج نطاق الجامعات والكليات. ويتعزز توجه برامج الدكتوراه لتضمين التدريب واكتساب المهارات على نحو لا يقل أهمية عن رسالة البحث والمهارات المكتسبة منها. وهو أمر بدأ بالظهور في عدد من الدول الأوروبية إضافة إلى المملكة المتحدة، استجابة لنداء الجهات الممولة والموظفة التي تقول إن التدريب في هذه البرامج يجب أن يكون متماشياً ومتحسساً لحاجة السوق.
وتعاني الجامعات البريطانية عدم وجود أسس عامة لتوحيد أسلوب المناقشة الشفهية لرسالة الدكتوراه فيما بينها. فهناك اختلاف قد يصل إلى حد التناقض فيما يخص هدف هذه المناقشة وطرق تطبيقها، جعل هذه المناقشة تعد اشتباكاً مرتباً أكثر من نقاش موضوعي نزيه. وتشهد السنوات الأخيرة تغيراً بطيئاً فيما يخص تركيز المناقشة على اختبار مهارات البحث المكتسبة، ونمو شخصية الباحث المستقلة، وتطوير المهارات الأساسية للعمل في جهات غير أكاديمية عند هؤلاء الذين يشغلون مناصب خارج نطاق الجامعات والكليات.
وتوضع الآن دراسات بريطانية لنسب الإكمال والانسحاب من برامج الدكتوراه؛ لاتخاذها مؤشراً على كفاءة البرامج النوعية. وتشير الدراسات المحدودة في هذا الشأن إلى تنوع العوامل المؤثرة في انسحاب باحث الدكتوراه من البرنامج، فبعضها يعزى إلى سمات الطالب أو مشكلاته الشخصية، أو مشكلات متعلقة بالبحث ونوع الإشراف عليه، أو العوامل المادية، أو التخصص؛ مع لفت النظر إلى أن طلاب أبواب التخصص العلمية يميلون إلى الإكمال أكثر من غيرهم.
حلول البيروقراطية
نشرت وكالة ضمان الجودة (Quality Assurance Agency) (ا2001م) مستنداً يوضِّح أن حامل شهادة الدكتوراه يجب أن يكون قادراً على تصور مشاريع أصيلة وتصميمها وتنفيذها لتوليد معارف جديدة واستيعاب أفضل للواقع، كذلك يجب أن يتمتع بالمهارات المطلوبة للتوظيف، والقدرات الإبداعية اللازمة لإصدار قرارات واعية وناضجة فيما يخص القضايا المعاصرة في مجال تخصصه.
وقد عيَّنت هذه الوكالة المؤهلات اللازمة لحامل الدكتوراه والمعايير الواجب توافرها في برنامج الدراسات العليا. وعلى الرغم من الترحيب بأهداف هذه المعايير الساعية لإحداث تطوير نوعي، يشير النقاد إلى حلول البيروقراطية لنظم التعليم العالي وفرض معايير خارجية قد لا تلائم الاختلاف النوعي بين أبواب تخصص الدكتوراه المختلفة.
جدير بالذكر أن تنوع درجات الدكتوراه في المملكة المتحدة يشكِّل استجابةً لحاجة المجتمع، فظهرت -على سبيل الذكر لا الحصر- أشكال مختلفة لبرامج الدكتوراه المهنية، وبرامج الدكتوراه المدمجة (Integrated PhD)؛ التي تسعى إلى جذب الأشخاص المميزين من مختلف دول العالم لما تحويه من رسالة بحث أصغر ومدة إكمال أقصر ورسوم دراسية أقل، إضافة إلى التدري والحلقات الدراسية في مجال التخصص.
سوق العمل الأوروبي والدكتوراه
بعد التخرج من الجامعات البريطانية إلى سوق العمل (حيث الإحصاءات المتوافرة عن توظيف حاملي الدكتوراه في الدول الأوروبية لا تزال محدودة) توظَّف نسب كبيرة من المتخرجين في مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث، ونسبة أخرى كبيرة أيضاً تجد وظائف لها خارج القطاع الأكاديمي.
وعلى الرغم من أن توظيف حملة الدكتوراه في المؤسسات غير الأكاديمية أضاف قوة معرفية ومهنية إلى هذه المؤسسات، إلا أن الموظِفين فيها لا يتطلعون إلى مؤهلات علمية عالية بقدر ما تعنيهم مناسبة السمات والمهارات الشخصية لطبيعة العمل لديهم. لذا فإن حاملي الدكتوراه لا يجدون فرقاً بينهم وبين أصحاب البكالوريوس من ناحية الرواتب والأمن الوظيفي؛ إذ ان رواتبهم تكاد تتساوى، وقد تكون غير مرضية لهم في دول مثل فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة.
تطوير هنا.. تجديد هناك.. توجهات تدريب.. نداءات المسؤولية.. معايير وطنية.. جسور معرفية.. آفاق متنوعة نابضة بالحياة، تدفعنا إلى دراسة واقع الدكتوراه في العالم العربي.. والسؤال لماذا هو متنح عن ساحة المنافسة والقوة العالمية.
ليست هناك جامعات.. هناك جامعيون
سأل سائل صديقاً له عن معنى نيله شهادة الدكتوراه قائلاً: هل قيمة هذه الشهادة بنفسها أم بحاملها أم بالمؤسسة الجامعية التي أعطتها؟ .
واحتار الصديق، في الجواب لأن السؤال وُضع بصيغة تفضيل أحد الأجوبة المحتملة الأخرى. إلا أنه تنبَّه في نهاية الأمر إلى أن الجواب مركَّب وغير بسيط . فالشهادة العلمية العالية مهمة بنفسها؛ لأنها بمثابة إعلان بأن حاملها قد حَصل على درجة علمية في مادة أكاديمية، في العلوم أو الآداب، بعد سنوات طويلة من الجهد الذي يجعله قادراً على مناقشة ما ينشر عن هذه المادة، وتقييمه ونقده والاستفادة منه. أو أن هذا ما يجب أن يكون.
كما أن الدكتوراه مهمة بحاملها أيضاً فليس كل الحاصلين على الدرجة العلمية نفسها سواسية في العلم. فهناك الذي يقف عند حدود ما تلقى لا يتقدَّم بعده قيد أُنملة، لأنه كان يبغي اللقب أكثر من لب الموضوعات التي درسها. وبهذا قال أحد الظرفاء الدكتوراه هي بكوية العصر الحديث! .
وهناك من يرى أن الدكتوراه -وإن كانت أعلى مرتبة في سلم التعليم الجامعي- فإنها أيضاً بداية لزيادة البحث والتحصيل. لأن ما هو جديد اليوم قديم غداً. وأسئلة الإنسانية، كالنهر المتدفق، لا تنقطع جرياناً وتغيراً. والباحث الجاد يجد أجوبة جديدة ينتفع بها مجتمعه والعالم. لهذا، فإن الذين حصلوا على الدكتوراه كثيرون، لكن الذين برزوا في ميادين تخصصهم قلائل انتشرت أسماؤهم واشتهرت لما بذلوا وجددوا.
أما أهمية المؤسسة التي تمنح الدكتوراه فلا تنكر. فالمؤسسات التعليمية تتفاوت في مستوى أساتذتها وقدراتها على توفير أساليب البحوث وطرقها وأجوائها من مختبرات ومكتبات وتمويل لمستلزمات البحث التي قد يحتاج إليها الطالب. من هذا المنطلق يجرى ترتيب أهمية الجامعات في هذا البلد أو ذاك ولا سيما في بلدان الغرب.
بالطبع يتفاعل عامل اجتهاد الطالب مع العاملين الآخرين بطرق مختلفة تُنتج دكتوراً باحثاً لامعاً أو عادياً. وليس من شك في أن للعامل الذاتي التأثير الأكبر. لأن الطالب الذي يعمل بجد، ولو في جامعة متوسطة القدرات التعليمية، قادر على التفوق على طالب يعمل بطاقة عادية في جامعة مميزة. وهناك قول فرنسي بهذا المعنى: ليست هناك جامعات.. هناك جامعيون! أي أن المؤسسة لا تستطيع أن تصنع بمفردها الطالب المتفوق، وإلا لكان جميع المتخرجين في جامعة هارفرد الأمريكية مثلاً، وهي أشهر جامعة في العالم الآن، متفوقين ولامعين إلا أن الأمر ليس كذلك بالتأكيد. فالطالب هو العامل الأساس بما يحمل من أسئلة وصبر وذكاء وقدرة على استخدام الجامعة ومرافقها للتوصل إلى حلول جديدة في الحقل الذي ينتمي إليه.
عن إشكالية الدكتوراه في السعودية
أشرف إحسان فقيه
في الوسط العربي عموماً، وفي السعودية والخليج خاصة، حيث تعدّ الألقاب عناصر مهمة في لعبة المكانة والنفوذ، يحظى لقب الدكترة بميزة خاصة لأنه جسر بين عالمين: العالم التقليدي القائم على الرتب القبَلية والاجتماعية، والعالم العصري بمفرداته الحداثية اللمّاعة.
ولعل هذا هو مكمن الإشكالية. فاللقب الأكاديمي ليس مكرمة أُسبغت على صاحبها. بل هو شهادة إثبات لقيَم علمية واحترافية معينة. وفي الوسط المحلي، حيث لا تحظى القيَم العلمية ولا الاحترافية بحيّز تأثير واسع، جُيِّر هذا اللقب لصالح القيمة الفخرية التي يُضمرها؛ ليغدو مثله مثل ألفاظ شيخ وباشا.
لمشكلة الدكتور في القاموس المحلي وجه آخر أيضاً. فبقدر ما يُجل نصف المجتمع حامل هذا اللقب الفانتازي ويتوقَّع منه الخوارق، فإن النصف الآخر لا يربطه إلا بالعبثية وبالإيغال في التفلسف. وهي نظرة تستند إلى صور نمطية خاصة بالمشتغلين في القطاع الأكاديمي، وإلى واقع تنموي غير مُرضٍ غذّته علاقة غير مكتملة الملامح بين المثقف الأكاديمي من جهة، وبقية شرائح المجتمع من جهة أخرى.
جذور إشكالية الدكتور
لم يعرف المجتمع السعودي الدرجات العلمية العليا إلا متأخراً. فيما تأسست أولى جامعات المملكة أواخر الخمسينيات الميلادية. لكن هذا الفقر الأكاديمي لم يلبث أن انقلب تماماً خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات التي شهدت طفرة حقيقية في عدد الجامعيين وفي برامج الابتعاث للجامعات الغربية. وإذا لاحظنا أن هذه الطفرة الأكاديمية قد تزامنت تماماً مع الطفرة النفطية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، وسعنا أن نفهم طبيعة الظرف الاجتماعي الذي رافق نشوء الأجيال التالية من الأكاديميين السعوديين.
وقد سوَّغ التوسع المباغت في النشاط التنموي الحاجة إلى الكفاءات الجامعية، وهو ما لم تتأخر الدولة في دعمه عبر البعثات، وعبر خلق القنوات الرسمية الرافدة له في صيغة عدد من الجامعات الحكومية (سبع جامعات كبيرة حتى العام 2000م).
إلا أن هذه المكونات المحدودة مثّلت، مع الأسف، كامل دورة الحياة الأكاديمية في المملكة. فالتأثير الأكاديمي ظل محصوراً بين جدران الجامعات، وهذه انحصرت علاقتها بالجمهور في حدها الأدنى (مَنح شهادة البكالوريوس) دون أن تصبح الدراسة العليا -المحلية- هماً حقيقياً للجانبين. كذلك لم يتقدم المشروع التنموي على الصعيدين العلمي والإنساني، ليُمكّن العائدين من بعثاتهم من نقل خبراتهم إلى المجتمع على النحو الأمثل.
في ضوء هذه الظروف وسواها، تكوَّنت ثقافة أكاديمية محلية قائمة على ما يمكن تسميته الحد الأدنى من الإنجاز. مظاهر هذه الثقافة يمكن تلخيصها من المنظور الفردي في المسار التالي: الالتحاق بعضوية هيئة التدريس بجامعة محلية، الحصول على بعثة للدراسة بالخارج، الحصول على درجة علمية ومن ثم العودة دكتوراً للوطن والاشتغال بالتدريس وبشيء من البحث العلمي.. أو ربما الاستغناء عن الوسط الأكاديمي بالكلية.
للتصوّر أعلاه استثناءات وفروع عديدة، بالذات فيما يتعلق بتجارب ابتعاث الشركات الكبرى مثلاً وغير المرتبطة بالملاك الأكاديمي الرسمي. إلا أن هذا التصور يظل منطبقاً على الكثرة الساحقة من الحالات ما يسوّغ اعتداده سياقاً عاماً للتقييم. وهو يمثِّل قاعدة مناسبة لدراسة الظاهرة لأنه لم يحوِ -عمداً- تفاصيل عن نقل التجربة الحضارية من الغرب، ولا تطور البحث العلمي الوطني، ولا علاقة جامعاتنا بباقي مؤسسات المجتمع.. وهي كلها شجون أساسية لهذا الحديث.
على من نُلقي باللائمة؟
بين رباعية الأكاديمي-الجامعة-الدولة-والمجتمع، تتوزع التهم المتعلقة بالدور الضائع عند الدكتور.
فالجامعات متهمة بالانشغال بمشكلاتها والاكتفاء بدور الموّرد للشهادات الأولية على حساب برامج الدراسات العليا ودعم البحث العلمي والتواصل مع المؤسسات الإبداعية والشعبية. الأكاديميون من جهتهم متهمون بتقمص دور الضحية فيما هم المحركون الحقيقيون للقطاع الجامعي والمطالَبون أصلاً بتغيير النظام الجامد المتهم، من قبلهم، بقتل الإبداع وتثبيط جهود المميزين منهم. هناك شريحة عريضة من هؤلاء متهمة بالانحدار بمستوى التدريس الجامعي وبتشويه صورة القطاع الأكاديمي كله في أعين العامة.
القطاعات الصناعية والتنموية متهمة بأنها قد قصرت عن دورها ولم توفِّر بيئات تطوير حقيقية تنهض بالمجهود الأكاديمي الخام وتوفِّر له مجالات تطبيق وتسويق على غرار وادي السليكون.. مثلاً. كذلك لم تخلق أجواء تنافس للمؤهلين أكاديمياً الذين فوجئوا بالبون الشاسع بين بيئات البحث في أوطانهم وتلك حيث تحصلوا على شهاداتهم.
المجتمع كله أيضاً متهم بأنه رفض معايير الحداثة التي عاد بها المبتعثون وأنه قد استعصى على ثقافات الاحترافية والعملية التي حاول أن يرسِّخها به هؤلاء.. ليستسلموا في نهاية المطاف ويصبحوا جزءاً من المنظومة القائمة على معايير شخصية وأُسرية في المقام الأول.
بين هذه التهم المتبادلة هنا وهناك تبرز حقائق لا مفر من مواجهتها. أولها كون النظام الأكاديمي في صيغته الحاضرة مشجعاً فعلاً على بذل الحد الأدنى من العطاء. نجاح الدكتور مقترن في الغالب بنشاطه الاستشاري وصِلاته الخاصة لكن ليس بالضرورة بمدى تميز نشاطه البحثي وجدّه. هذه حقيقة معروفة عبر الامتداد العربي بأسره وليست المملكة استثناءً له. وفي الحالة السعودية بالذات، الدكتور السعودي لن يجد من يحاسبه لو لم تنشر له أية ورقة علمية طول سنوات. ثمة تقاعس غالباً ما يعزى إلى الغرق في مشاغل التدريس، أو المهام الإدارية داخل الجامعة، أو حتى الانشغال –عياناً بياناً- بتحسين مستوى الدخل الذي لا ينصفه العمل الأكاديمي.. كما يؤكد الأكاديميون.
ثمة حقيقة أخرى جديرة بالملاحظة. فالأكاديميون السعوديون، الذين يتلقّى بعضهم تعليماً مميزاً في أفضل جامعات الغرب الصناعي، سرعان ما يجدون أنفسهم مؤهلين فوق الحاجة في مجتمعاتهم غير الصناعية حيث لا ينشئ اقتصاد المعرفة علامات فارقة في المشهد المحلي. وهي ملاحظة تنطبق كذلك على مستوى التدريس الذي يقدمه هؤلاء لطلبتهم. هذه الحقيقة تدفع بعدد متزايد من دارسي الشهادات العليا إلى اعتماد نظرة أكثر واقعية. فلماذا المعاناة مع جامعة أمريكية من الصف الأول؛ طالما الأمر لا يعدو إضافة سابقة د. للاسم.. بغض النظر عن مصدرها؟!
لنتكلم عن (المثقَّف) عموماً
كل الكلام أعلاه وإن جرى تعميمه على كامل التجربة الأكاديمية، إلا أنه يركّز في الواقع على الجانب العلمي من هذه التجربة. إذ ان هنالك أكاديميين غير معنيين بهموم الصناعة والتكنولوجيا. هؤلاء متخصصون في الشأن الإنساني.. مفكرون وأدباء وقانونيون وفقهاء. وهم في صميم الإشكالية المطروحة ها هنا. فالأكاديمي ذو التخصص الأدبي -كما في العرف الشعبي- وغالباً ما يستحوذ على لقب المثقَّف أيضاً، أقرب إلى مواجهة الجمهور والتعاطي معه من نظيره العلمي، بحكم طبيعة تخصصه وطبيعة الاهتمام المحلي. وفي بيئة حساسة تجاه موروثها الفكري والاجتماعي كما هي بيئة الجزيرة العربية، فإن الصدام بين التقليدي والحداثي كان أشد قسوة عما في الباقي العربي. الدارسون الذين عادوا من الخارج محملين بمجموعة من الطروحات والأفكار الحديثة، واجهوا صعوبة في تداول هذه الأفكار والتبشير بها، حتى على الصعيد الأكاديمي البحت.
هذا الصدام بين التقليدي والحداثي كانت له نتائج مهمة عبر المجتمع بأسره. فهو رسَّخ أولاً نظرة اشتباهية بالمثقَّف-الأكاديمي-الدكتور، أياً كان تخصصه في مقابل الشيخ التقليدي المستند لمصفوفة فكرية وتراثية شديدة التجذر بالوعي الشعبي. كذلك خلط هذا الصدام توزيع الأدوار بين هذه الرموز وأدى إلى ظهور تصنيفات اعتباطية قسّمت المدارس الفكرية، عبر عدة انتماءات إيديولوجية، دون أسس واضحة في الحالة السعودية بالذات.
أدى هذا الصدام كذلك إلى إضعاف نفوذ الأكاديميا التي علِق أصحابها في معارك جانبية مع مناوئيهم. وإلى أدلجة خطوط التواصل بين المثقَّف عموماً من جهة، ورجل الشارع العادي من جهة أخرى، وأثر في مستوى الوعي الفكري في المجتمع السعودي وفي المنتج الثقافي السعودي أيضاً.
أسئلة أخرى مفتوحة
هموم الدكتور السعودي تبدو أكثر من أن تحويها هذه المساحة. وهناك أسئلة وملاحظات أكثر تنتظر الطرح. فالتعلل برفض المجتمع لقيم الحضارة الوافدة مع الدارسين الأكاديميين لا يلبث أن تكسّره مظاهر التغريب الواضحة في شوارع المدن السعودية وخلف أبواب منازلها. الأكاديميون ليسوا وحدهم سفراء أوطانهم في الغرب. لماذا إذن تُعلق بأعناقهم هم مسؤولية نقل صورتنا الإيجابية للغرب؟ ولماذا يتحملون هم وزر الصورة الشائهة للسعودي هناك؟
وإذا كان التكنوقراط قد تحصلوا أخيراً فقط خلال العقد الأخير على فرصتهم في إدارة التجربة التنموية المثقلة بأخطاء الماضي، فهل يسعنا أن ننتظر أكثر نتائج تجربتهم؟ أم ان على هؤلاء أن يتوقفوا عن لعب دور جوكر المناصب ويزدادوا انغماساً في عوالمهم الأكاديمية ليقيلوها من عثراتها الذاتية؟ هل سيستمر المجتمع بالتطلع بشك وريبة للمثقف الأكاديمي على أساس أن ما يصدر عنه هو كلام كتب لا يناسب واقعنا ذي الخصوصية الفريدة؟ أم ان أكاديميينا يمتلكون عن حق حلولاً سحرية لإشكاليات المجتمع؟.. حلولاً تليق بالهالات المهيبة التي تحيط بهم وبألقابهم وشهاداتهم المؤطرة القادمة من عوالم ما وراء البحار!
اقرأ للدكتوراه
نحن البحَّاثة
من السير بموازاة المجتمع إلى التفاعل معه
معظم الكتب التي تتناول الحديث عن الجامعات والمشكلات التي تعترضها غالباً ما تتحدّث عن الميول السياسية عند الأساتذة الذين يدرّسون فيها، ومصادر تمويل الأبحاث التي يقومون بها، ومدى تأثيرها في مسار تلك الأبحاث ونتائجها، والمعايير التي يعتمدون عليها في اختيار الكتب والمراجع التي يتبعونها في المواد التي يدرِّسونها. إلا أن كتاب: نحن الأكاديميون: تغيير ثقافة الجامعة للكاتب دايفيد دامروش يتناول فكرة هيكل البناء الأكاديمي والمشكلات التي تعتريه. ومن أهم هذه المشكلات، تلك الناتجة من التخصص الزائد الذي يسود معظم الجامعات في أيامنا الحاضرة ومشكلة العزلة عن المجتمع الذي يحيط بها.
تكوَّن شكل الجامعات الأمريكية الجديد خلال نحو 20 سنة، بين أوائل 1870م حتى منتصف 1890م. في ذلك الوقت، ظهرت أبواب التخصص المتعدّدة، وظهرت معها بيروقراطية الحياة الأكاديمية الجديدة. فالتخصصية أو التخصص الزائد كان نتيجة الثورة الصناعية التي حدثت آنذاك. إذ استدعى ظهورها إعادة ترتيب المواد التي تدرّس في الجامعات وجمعها، لتشكّل كلّ مجموعة منها اختصاصاً معيناً يعبِّر عن متطلّبات الصناعة الجديدة. كذلك تطلّب الأمر استحداث مواد جديدة لم تكن تُدرَّس من قبل. فبدأ الأساتذة الجامعيون يتحدثون عن إنتاج المعلومات بدلاً من الحديث عن الحفاظ على التراث . وهكذا، تمايزت أبواب الاختصاص المختلفة بفصلها بعضها عن الآخر وإنشاء الدوائر الأكاديمية المختلفة. واستوجبت إدارة تلك الدوائر وجود بيروقراطية معينة تعمل على إدارتها.
ومع بداية القرن العشرين ومع زيادة الاهتمام بالبحاثة الأكاديميين واعتمادهم مستشارين وزيادة تمويلهم لدى الحكومات والمؤسسات المدنية، ومع توسع النظام الأكاديمي، بدأ عدد كبير من المثقفين من الكتَّاب والمهتمين بالاستراتيجيات الدفاعية، بالالتحاق بالجامعات المختلفة، خاصة في الغرب. وهكذا، أخذت المشكلات العامة تجد لها حلولاً عند البحاثة الأكاديميين داخل حرم الجامعات أكثر من المثقفين المستقلين الذين كانوا يموّلون أنفسهم من خلال مداخيل خاصة أو من خلال الكتابة الحرّة.
إلا أن هجرة العقول إلى الحياة الأكاديمية كان لها ثمن. إذ انها تحد معالجة المشكلات العامة لأن هذه العقول تصبح محدودة بالتخصص الزائد في الجامعات، وهذا يفرض عزلة ما تحدّ تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات فيما بينها وينشئ حاجزاً معيناً مع المجتمع الذي يحيط بها. وبالتالي، لا تكون الحلول الشاملة والشافية لمشكلات المجتمع المختلفة متوافرة.. بالإضافة إلى ذلك، أضرَّ هذا التخصص بالمجتمع المحيط بالحرم الجامعي.
وقد لاحظ العالم الأمريكي جون دوي منذ عام 1916م في كتابه الديمقراطية والتعليم أن التجزئة المتزايدة في البرامج الأكاديمية أدت إلى عزلة المجموعات الاجتماعية في المجتمع العصري . إذ ان المجتمع المعاصر يبرع في التخصص والفردية ويسوده منطق ثقافي معروف بميله إلى بناء هوية المجموعات من خلال الاهتمامات الفردية والخلفية الثقافية المشتركة. وتسهم هذه المسألة في إضعاف المجتمع، إذ تحد انفتاح بعضه على بعض وتخلق الكثير من المشكلات الاجتماعية.
أما اليوم فتقع المؤسسات الأكاديمية، وكذلك المؤسسات العامة، تحت ضغوط نتيجة تدفق المعلومات والترابط السياسي والمادي الناتج من العولمة بين المجتمعات المختلفة. لذلك، ضروري إقامة الإصلاحات الإدارية في الدوائر المختصة وتوجيه الأكاديميين إلى العمل بطريقة منفتحة، تمكّن من معالجة الأمور والمسائل العامة بطريقة أفضل.
وأول خطوة في الإصلاح الأكاديمي وأهمها هي إعادة تقويم المجموعة البحثية الأكاديمية وإعادة فهمها. فهذه الصورة السائدة عند الأكاديميين أن العزلة والتقوقع بعيداً عن المجتمع تساعد في صفاء الذهن وابتداع الأفكار الخلاَّقة، والمقولات السائدة بينهم مثل أنه لا يمكن لمجموعة من الأشخاص أن تمسك قلماً واحداً وأن كل الأفكار المهمة تنبثق من عقل واحد لا من عدة عقول .. كلها أفكار تعزز الانعزال والبعد عن المشاركة الفكرية العامة. وفي هذا الصدد تقول البحاثة ماري دوغلاس: نحن لا نريد أن نكون مثل جهاز الحاسوب الذي لا يستطيع أن يعمل إلا من منظور البرنامج الموضوع فيه.. أملنا أن يكون لدينا الاستقلال الفكري لمواجهة أية حواجز يمكن أن تحد تفكيرنا. وأول خطوة في ذلك هي اكتشاف كيف أن قبضة المؤسسات، التي أصبحنا جزءاً منها، أسهمت وتسهم في خنق عقولنا. إذ كيف تكون لنا نظريات شافية ووافية في علم الاقتصاد إن لم يكن لدينا الاطلاع الكامل على العلوم السياسية، وكيف يمكننا الغوص في عالم الطب إذا لم تكن عندنا الدراية الكاملة بالعلوم النفسية وهكذا.
هذا عن الانفتاح ضمن المجموعة الأكاديمية في الجامعات المختلفة. أما عن العلاقة مع المجتمع الخارجي، فيجب ألاّ تسير المجموعة الأكاديمية بطريقة موازية للمجتمع وإنما بطريقة تتفاعل معه. فمثلاً، تفاعلت الجامعات مع متطلبات المجتمع مثل التركيز على لغة الحاسوب أكثر بكثير من التركيز على تعليم اللغة اللاتينية مثلاً التي كانت مطلوبة سابقاً في معظم أبواب الاختصاص. لكن هذه الدينامية لا تعني استجابة الجامعات لكلّ متطلبات المجتمع الاستهلاكي الذي لا يعير اهتماماً كبيراً لدراسة أنواع الثقافة المختلفة مثل تاريخ الحضارات، لأن ذلك يُفقد الجامعة دورها الذي يجب أن تلعبه في تثقيف المجتمع وتطويره.
إذن المطلوب هو الاعتراف بضرورة التخصص لأننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا التخصص أسهم في خلق نظام ناجح جداً للتعليم العالي، إلا أن علينا استخدام هذا النظام بطريقة تسمح بالتفاعل والانفتاح ما بين أبواب الاختصاص المختلفة وما بين المجتمع الأكاديمي البحثي والمجتمع كله لأن ذلك يساعد في تقديم الحلول الشاملة التي تواجه أي مجتمع.
.........
مواضيع تستحق القراءة :
اهــــ(الأحداث)ــــم
النتائج 1 إلى 1 من 1
-
January 16th, 2013, 19:53 #1عضو فضي












- تاريخ التسجيل
- Dec 2010
- الدولة
- USA، واشنطن، زمالة
- العمر
- 49
- المشاركات
- 1,334
- معدل تقييم المستوى
- 77
 الدكتوراه ،،، اللقب واحد.. أما الموازين فمختلفة
الدكتوراه ،،، اللقب واحد.. أما الموازين فمختلفة
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)




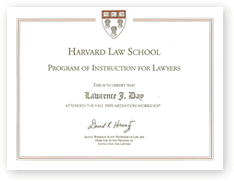



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
مواقع النشر