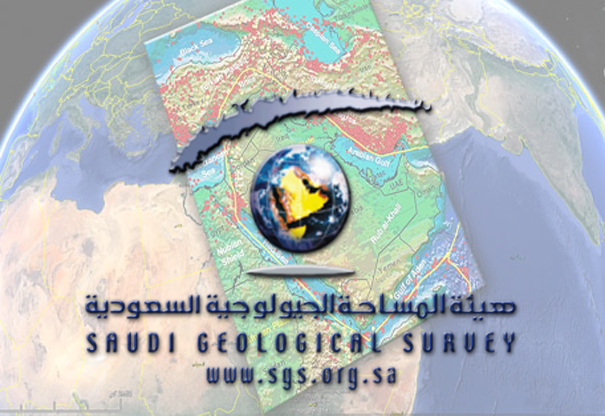شبكة CNN : مع تطور شكل الحياة وأنماطها تبرز مفاهيم وقضايا جديدة، لم تكن لتشغل بالنا من قبل، بعضها جاء نتيجة ايجابية تراكمية لما حققناه على امتداد سنوات من العمل والبناء، وبعضها أتى كاستحقاق على هذه المنجزات ليذكرنا بأن التطور في جوهره هو عملية موازنة بين عناصر عدة تتشابك وتتقاطع داخل مشهد واحد في غاية التعقيد والحساسية، وفي غاية الوضوح أيضاً، أي أن فهمه وتفكيكه لا يتم إلا بواسطة مفتاح وحيد يتمثل في الإجابة على سؤال: ما الذي يترتب علينا من واجبات، في مقابل كل ما حققناه من مزايا وانجازات؟

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة المناخ بباريس
ولعل أكثر هذه القضايا أهمية هي الاستدامة بشتى أنواعها، الاستدامة في شكل التطور الذي تحقق، الاستدامة في الموارد، والاستدامة في البيئة.
ويبدو أن هذه القضايا الحيوية التي يطرحها العصر، لا تبتعد كثيراً عن كونها صرخات استغاثة تعبّر عن هواجس الجنس البشري حول قدرته على البقاء وحول شكل ومستقبل بقائه، فلا ضير إذاً من التعبير عن هذه الهواجس طالما أنها تأتي ضمن مشروعية الحق في الحفاظ على سلامة الوجود، وسلامة المحيط، لأن هذا المحيط هو مصدر الحياة ومصدر الخلل في آن واحد.
بالأمس القريب، عقدت في باريس الدورة الواحدة والعشرين لقمة الأمم المتحدة للمناخ. لم تتباين مواقف المجتمعين في القمة حول التحديات التي يفرضها الانحدار الحاد للمناخ نحو الأسوأ، بل وحدها القلق على مصير الأرض، وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذه المواقف بالقول: "لكي أكون واضحًا، مصير اتفاق باريس بين أيديكم. مستقبل شعوبكم ومستقبل كوكبنا بين أيديكم، فلم نواجه ابدًا مثل هذا الاختبار من قبل".
الأكثر إثارةً للقلق كان تصريح المستشارة الألمانية انجيليكا ميريكل حيث قالت: "علينا الوفاء بالوعود التي قطعناها في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ عام 2009، وهي تخصيص مائة مليار دولار سنوياً حتى العام 2020." ويمثل هذا التصريح دليلاً على أن الخلافات السياسية الدولية تعطل المساعي لإنقاذ الكوكب. ويبدو أن عشرات الآلاف من الجماهير الغاضبة خارج قاعة الاجتماع كانت على حق في احتجاجها وعدم ثقتها بإمكانية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ليس من الغرابة ألا تلتزم الدول الصناعية الكبرى بخطوات فعالة لمواجهة التطرف المناخي، فهي لم تتفق على شؤون أقل من ذلك بكثير، مثل توحيد مفهوم التنمية والاستدامة من الأساس، مما جعل الرهان على اتفاق دولي لحل مشكلة المناخ ضرباً من المغامرة، ولكن ليس أية مغامرة، إنها المغامرة بالمستقبل وبكل ما هو جميل وضروري للعيش على سطح كوكبنا.
مما لا شك فيه أن الدراسات العلمية المختصة في هذا المجال خلصت إلى صيغ كثيرة من الحلول، لم يتم تبني هذه الحلول على نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة لأنه، وبكل بساطة، لا يمكن حل المعضلات بذات الأدوات التي أنتجتها، كما لا يمكن تغيير توجهات المناخ بدون تغيير جذري في توجهاتنا وثقافاتنا البيئية قبل أي شيء.
إن الحل المتاح أمامنا الآن، هو أن تقوم كل دولة ومؤسسة اقتصادية بما عليها بدون انتظار توافق دولي بهذا الشأن، وهذا يتطلب إعادة الاعتبار لشروط التنمية واستدامتها في الممارسة الاقتصادية. إن استدامة مصادر الثروات واستدامة المناخ كنتيجة، تفرض علينا الموازنة العادلة بين التطور الصناعي والاستقرار البيئي، أي اعتبار الحفاظ على الطبيعة وعلى قدرتها في انتاج مقومات الحياة هدفاً نهائياً للعمل، بحيث تصبح كل ممارسة اقتصادية لا تراعي هذا الشرط، ممارسة مدانة وخارجة على القانون. لقد أصبح هذا الشكل من العمل الاقتصادي ممكناً اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصةً بعد تنامي الاقتصاد الإسلامي وما يعنيه من إعادة توصيف العلاقة بين المال والتمويل والاستقرار البيئي والاجتماعي، فالتمويل الإسلامي يعتبر المحافظة على عناصر الصحة والسلامة البيئية شرطاً لإعمار الأرض وليس خياراً.
إن البيئة بعناصرها الأساسية كما جاءت في التشريع الإسلامي، هي ملك لجميع المخلوقات وليس للإنسان فقط، فمصادر الغذاء والماء والطاقة، وكل ما يتبعها من موجودات طبيعية للحفاظ على ديمومتها، تشكل عوامل البقاء على هذه الأرض، بدونها تنضب الحياة وتختفي مهما اجتهد البشر في ابتكار بدائل عنها. لذا أكرم الله الإنسان بالعقل والحكمة واستخلفه في الأرض ليمارس حكمته في الحفاظ على توازنها الطبيعي، ونهاه عن الفساد في الأرض. والفساد هنا يشمل كافي نواحي الحياة، فالفساد في إدارة الموارد يعني إفساداً لمصادرها، وهذا يتعارض مع الآية الكريمة: ""ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين" صدق الله العظيم.
من هنا نلمس مدى توافق التمويل الإسلامي المستند إلى هذه الشريعة مع ضرورات الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.
ولكن حتى اللحظة، وبسبب حداثة تجربة التمويل الإسلامي، لم نشهد الكثير من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، باستثناء مشروع إعادة تأهيل مباني المنطقة الحرة في جبل علي، دبي، المشروع الأول من نوعه في العالم والذي دخلت فيه شركة الصكوك الوطنية كشريك استثماري بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وهنا لا بد من الإشارة إلى مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على البيئة وتخصيص الكثير من البرامج والميزانيات والحملات التثقيفية لتعزيز هذا الجانب الحيوي، مما جعلها نموذجاً للموازنة بين أمرين لم يكن يُعتقد بإمكانية الجمع بينهما: الحداثة والاستدامة البيئية.
لا يمكن للاقتصاد وحده أن يحقق هذا التوازن بمعزل عن الثقافة الفردية والعامة التي يتحرك في إطارها. إذ كيف يمكن أن ننتج منظومة اقتصادية تراعي البيئة والسلامة في نشاطها من دون تعزيزها بقاعدة من المفاهيم والقيم التي تحاكمها على سلوكها وتعيد توجيهها إذا ضلت الطريق.
إن تعزيز ثقافة الاعتدال في الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة والثروات بكافة تجلياتها، يعتبر الخطوة الأولى لبناء مستقبل تسود فيه ثقافة مغايرة عن تلك التي رافقت نشوء المعضلات البيئية، مما يعني ضرورة التركيز على تنشئة أجيالنا القادمة وفق مفاهيم الاستدامة. إن هذه الأجيال التي ولدت وسط ضجيج المدن وتحت وطأة واقع بيئي مختل، لا تحمل في ذاكرتها صوراً عما كانت عليه البيئة قبل أن يولدوا. لذا علينا أن نكون نحن ذاكرتهم وجسرهم الذي يربط بين زمن ما قبل الاختلال المناخي وبين مستقبلهم. إنهم أصحاب القرار الاقتصادي في الغد، وبدون علاقة وجدانية عميقة بينهم وبين البيئة، سيفقدون العلاقة الوجدانية بين نشاطهم الاقتصادي وقراراتهم الضرورية لحماية محيطهم الطبيعي.
إن الاستثمار في الاستدامة وثقافتها استثمار مستدام في المقابل، فهو مرتبط بحاجات الناس الطبيعية، برغباتهم وتصوراتهم المتفائلة بالمستقبل. إذاً لا مخاطرة في مشاريع الاستدامة طالما تحاكي هذه الاحتياجات، بل أن كل المخاطرة تكمن في أي نشاط اقتصادي لا يراعي هذه الحقيقة، ولا يعمل على أن تكون غايته وهدفه في كل مرحلة من مراحل البناء والتطور.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة المناخ بباريس
هذا المقال بقلم محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، والآراء الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.
ويبدو أن هذه القضايا الحيوية التي يطرحها العصر، لا تبتعد كثيراً عن كونها صرخات استغاثة تعبّر عن هواجس الجنس البشري حول قدرته على البقاء وحول شكل ومستقبل بقائه، فلا ضير إذاً من التعبير عن هذه الهواجس طالما أنها تأتي ضمن مشروعية الحق في الحفاظ على سلامة الوجود، وسلامة المحيط، لأن هذا المحيط هو مصدر الحياة ومصدر الخلل في آن واحد.
بالأمس القريب، عقدت في باريس الدورة الواحدة والعشرين لقمة الأمم المتحدة للمناخ. لم تتباين مواقف المجتمعين في القمة حول التحديات التي يفرضها الانحدار الحاد للمناخ نحو الأسوأ، بل وحدها القلق على مصير الأرض، وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن هذه المواقف بالقول: "لكي أكون واضحًا، مصير اتفاق باريس بين أيديكم. مستقبل شعوبكم ومستقبل كوكبنا بين أيديكم، فلم نواجه ابدًا مثل هذا الاختبار من قبل".
الأكثر إثارةً للقلق كان تصريح المستشارة الألمانية انجيليكا ميريكل حيث قالت: "علينا الوفاء بالوعود التي قطعناها في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ عام 2009، وهي تخصيص مائة مليار دولار سنوياً حتى العام 2020." ويمثل هذا التصريح دليلاً على أن الخلافات السياسية الدولية تعطل المساعي لإنقاذ الكوكب. ويبدو أن عشرات الآلاف من الجماهير الغاضبة خارج قاعة الاجتماع كانت على حق في احتجاجها وعدم ثقتها بإمكانية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ليس من الغرابة ألا تلتزم الدول الصناعية الكبرى بخطوات فعالة لمواجهة التطرف المناخي، فهي لم تتفق على شؤون أقل من ذلك بكثير، مثل توحيد مفهوم التنمية والاستدامة من الأساس، مما جعل الرهان على اتفاق دولي لحل مشكلة المناخ ضرباً من المغامرة، ولكن ليس أية مغامرة، إنها المغامرة بالمستقبل وبكل ما هو جميل وضروري للعيش على سطح كوكبنا.
مما لا شك فيه أن الدراسات العلمية المختصة في هذا المجال خلصت إلى صيغ كثيرة من الحلول، لم يتم تبني هذه الحلول على نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة لأنه، وبكل بساطة، لا يمكن حل المعضلات بذات الأدوات التي أنتجتها، كما لا يمكن تغيير توجهات المناخ بدون تغيير جذري في توجهاتنا وثقافاتنا البيئية قبل أي شيء.
إن الحل المتاح أمامنا الآن، هو أن تقوم كل دولة ومؤسسة اقتصادية بما عليها بدون انتظار توافق دولي بهذا الشأن، وهذا يتطلب إعادة الاعتبار لشروط التنمية واستدامتها في الممارسة الاقتصادية. إن استدامة مصادر الثروات واستدامة المناخ كنتيجة، تفرض علينا الموازنة العادلة بين التطور الصناعي والاستقرار البيئي، أي اعتبار الحفاظ على الطبيعة وعلى قدرتها في انتاج مقومات الحياة هدفاً نهائياً للعمل، بحيث تصبح كل ممارسة اقتصادية لا تراعي هذا الشرط، ممارسة مدانة وخارجة على القانون. لقد أصبح هذا الشكل من العمل الاقتصادي ممكناً اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصةً بعد تنامي الاقتصاد الإسلامي وما يعنيه من إعادة توصيف العلاقة بين المال والتمويل والاستقرار البيئي والاجتماعي، فالتمويل الإسلامي يعتبر المحافظة على عناصر الصحة والسلامة البيئية شرطاً لإعمار الأرض وليس خياراً.
إن البيئة بعناصرها الأساسية كما جاءت في التشريع الإسلامي، هي ملك لجميع المخلوقات وليس للإنسان فقط، فمصادر الغذاء والماء والطاقة، وكل ما يتبعها من موجودات طبيعية للحفاظ على ديمومتها، تشكل عوامل البقاء على هذه الأرض، بدونها تنضب الحياة وتختفي مهما اجتهد البشر في ابتكار بدائل عنها. لذا أكرم الله الإنسان بالعقل والحكمة واستخلفه في الأرض ليمارس حكمته في الحفاظ على توازنها الطبيعي، ونهاه عن الفساد في الأرض. والفساد هنا يشمل كافي نواحي الحياة، فالفساد في إدارة الموارد يعني إفساداً لمصادرها، وهذا يتعارض مع الآية الكريمة: ""ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين" صدق الله العظيم.
من هنا نلمس مدى توافق التمويل الإسلامي المستند إلى هذه الشريعة مع ضرورات الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.
ولكن حتى اللحظة، وبسبب حداثة تجربة التمويل الإسلامي، لم نشهد الكثير من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، باستثناء مشروع إعادة تأهيل مباني المنطقة الحرة في جبل علي، دبي، المشروع الأول من نوعه في العالم والذي دخلت فيه شركة الصكوك الوطنية كشريك استثماري بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وهنا لا بد من الإشارة إلى مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على البيئة وتخصيص الكثير من البرامج والميزانيات والحملات التثقيفية لتعزيز هذا الجانب الحيوي، مما جعلها نموذجاً للموازنة بين أمرين لم يكن يُعتقد بإمكانية الجمع بينهما: الحداثة والاستدامة البيئية.
لا يمكن للاقتصاد وحده أن يحقق هذا التوازن بمعزل عن الثقافة الفردية والعامة التي يتحرك في إطارها. إذ كيف يمكن أن ننتج منظومة اقتصادية تراعي البيئة والسلامة في نشاطها من دون تعزيزها بقاعدة من المفاهيم والقيم التي تحاكمها على سلوكها وتعيد توجيهها إذا ضلت الطريق.
إن تعزيز ثقافة الاعتدال في الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة والثروات بكافة تجلياتها، يعتبر الخطوة الأولى لبناء مستقبل تسود فيه ثقافة مغايرة عن تلك التي رافقت نشوء المعضلات البيئية، مما يعني ضرورة التركيز على تنشئة أجيالنا القادمة وفق مفاهيم الاستدامة. إن هذه الأجيال التي ولدت وسط ضجيج المدن وتحت وطأة واقع بيئي مختل، لا تحمل في ذاكرتها صوراً عما كانت عليه البيئة قبل أن يولدوا. لذا علينا أن نكون نحن ذاكرتهم وجسرهم الذي يربط بين زمن ما قبل الاختلال المناخي وبين مستقبلهم. إنهم أصحاب القرار الاقتصادي في الغد، وبدون علاقة وجدانية عميقة بينهم وبين البيئة، سيفقدون العلاقة الوجدانية بين نشاطهم الاقتصادي وقراراتهم الضرورية لحماية محيطهم الطبيعي.
إن الاستثمار في الاستدامة وثقافتها استثمار مستدام في المقابل، فهو مرتبط بحاجات الناس الطبيعية، برغباتهم وتصوراتهم المتفائلة بالمستقبل. إذاً لا مخاطرة في مشاريع الاستدامة طالما تحاكي هذه الاحتياجات، بل أن كل المخاطرة تكمن في أي نشاط اقتصادي لا يراعي هذه الحقيقة، ولا يعمل على أن تكون غايته وهدفه في كل مرحلة من مراحل البناء والتطور.


 أقسام درة ،،،
أقسام درة ،،،